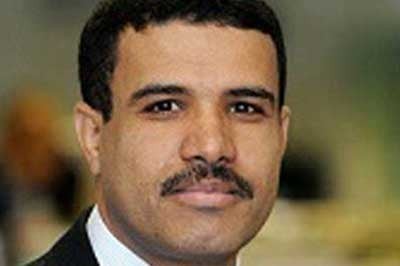02:32 2025/09/07
06:53 2025/09/05
الهاشمية السياسية في اليمن من "حق البطنيين" إلى استعادة الإمامة عبر الحوثيين (2-1)
11:54 2025/07/29
تمثل الهاشمية السياسية في اليمن امتدادًا حديثًا لموروث ديني-طبقي نشأ في صلب المذهب الزيدي، وتحديدًا داخل التيار الجارودي الذي غلّب الاصطفاء السلالي على المفهوم التقليدي للشورى. وقد هيمن هذا التيار على المشهد الفقهي الزيدي منذ القرن الثامن الهجري، مقابل محاولات تجديدية محدودة قادها علماء كبار من داخل الزيدية أنفسهم كالإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، والإمام الشوكاني، والإمام محمد بن إبراهيم الوزير، الذين واجهوا فكر الحصر السلالي بمنهجيات تعتمد على النص والاجتهاد والانفتاح على مقاصد الشريعة لا على الانتماء النسبي. إلا أن التيار الجارودي ظل الأكثر تمسكًا بأن "الإمامة لا تجوز إلا في البطنين"، أي في سلالة الحسن والحسين، وهو ما أدى إلى تحويل الحكم إلى حق مكتسب لطبقة دينية محددة، وتكريس ثقافة النسب كمعيار أعلى من الكفاءة والاختيار الشعبي. (انظر: الشوكاني، السيل الجرار؛ ابن الوزير، الروض الباسم؛ الصنعاني، تطهير الاعتقاد)
لقد استخدم الأئمة الزيديون هذا التصور السلالي لتبرير احتكارهم للحكم طوال قرون في شمال اليمن، مقدمين أنفسهم كـ"ظل لله في الأرض"، حتى حين كانت سلطتهم تفتقر إلى أي إجماع شعبي أو شرعية واقعية. وقد ترافق هذا مع تكوين نخبة دينية-اجتماعية هرمية، خاضعة لمرجعية دينية مركزية، ظلت حتى القرن العشرين تتحكم بمفاصل الدين والمجتمع والتفسير والفتوى. هذا المشروع لم يُهزم بشكل نهائي بثورة 1962، بل تراجع سياسيًا مؤقتًا فقط، بينما بقيت بنيته الفكرية والاجتماعية قائمة، لتجد فرصتها من جديد بعد المصالحة الوطنية عام 1970.
عندما أطاحت ثورة 26 سبتمبر 1962 بالإمام محمد البدر، نجل الإمام أحمد، بدا لوهلة أن اليمن بدأ في كتابة فصل جديد من تاريخه، قائم على الجمهورية والمواطنة والمساواة السياسية. لكن الواقع أن النظام الإمامي، وإن خسر المعركة العسكرية، لم يخسر أدواته الاجتماعية والرمزية، بل حافظ على وجوده من خلال البنية القبلية، والعلاقات الخارجية، والدعم السعودي الذي كان حاسمًا في إبقاء المشروع الإمامي حيًا على أطراف المشهد. (انظر: عبده خالد و قراءة في "اليمن الجمهوري" للبردوني، ط.1985)
ومع انسحاب مصر من اليمن بعد نكسة 1967، و إزاحة المشير عبدالله السلال، دخلت الجمهورية اليمنية في مرحلة اضطراب، استغلها الملكيون والمجتمع الدولي للضغط على القيادة الجمهورية للقبول بما سمي "المصالحة الوطنية" عام 1970، بقيادة الرئيس القاضي عبدالرحمن الإرياني، الذي كان يؤمن بأن استقرار الجمهورية يتطلب عودة من يسمون بـ"العلماء والسادة" إلى مؤسسات الدولة. تم بموجب ذلك دمج العشرات من رموز الهاشمية السياسية، الذين قاتلوا مع الملكيين، في الحكومة، ومجلس الشورى، والقضاء، والأوقاف، والجيش، بحجة التوازن، في ما مثّل عودة ناعمة للمشروع الإمامي تحت مظلة الجمهورية. (راجع: أوراق المصالحة الوطنية – مركز البحوث اليمني، صنعاء 1971)
بعد عام 1970، ومع استقرار النظام الجمهوري الشكلي، بدأ الوجود السلالي يعيد تشكيل نفسه بهدوء داخل الدولة، لا من بوابة العنف هذه المرة، بل من خلال مؤسسات الثقافة والتعليم والدين والإعلام. وقد برز هذا بوضوح في إعادة تفعيل مدارس تحفيظ مرتبطة برموز زيدية متشددة، وفي استعادة الخطاب الفقهي السلالي في المساجد، وعودة النسب كعنصر تمييز داخل المجتمع، إلى جانب تسلل عدد من الرموز الهاشمية إلى سلك القضاء والجيش والوظائف العليا.
كل ذلك جرى بدعم خفي أو تغاضٍ ضمني من النظام الحاكم، الذي وجد في هذا التوازن مدخلًا لضبط المجتمع اليمني. (انظر: مركز الدراسات السياسية – صنعاء، تقرير 2002 حول التعليم الديني والمذهبي).
وفي هذا السياق، ظهرت الشبكات الثقافية والفكرية المرتبطة بإيران، والتي قدمت نفسها تحت عناوين التشيع الثقافي، و"أهل البيت"، والدفاع عن "الهوية الزيدية"، لكنها كانت في الحقيقة تبني جسورًا أيديولوجية مع الثورة الخمينية، وتؤسس لجيل جديد من الهاشمية السياسية المسلحة، وهو ما تمثّل لاحقًا بجماعة الحوثي. (راجع: تقرير معهد واشنطن – "إيران والحوثيون: التمدد عبر الثقافة والتعليم"، 2015).
*أكاديمي ومحلل سياسي يمني